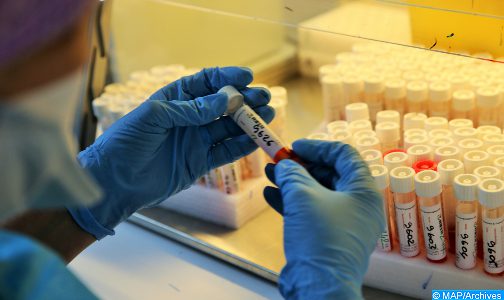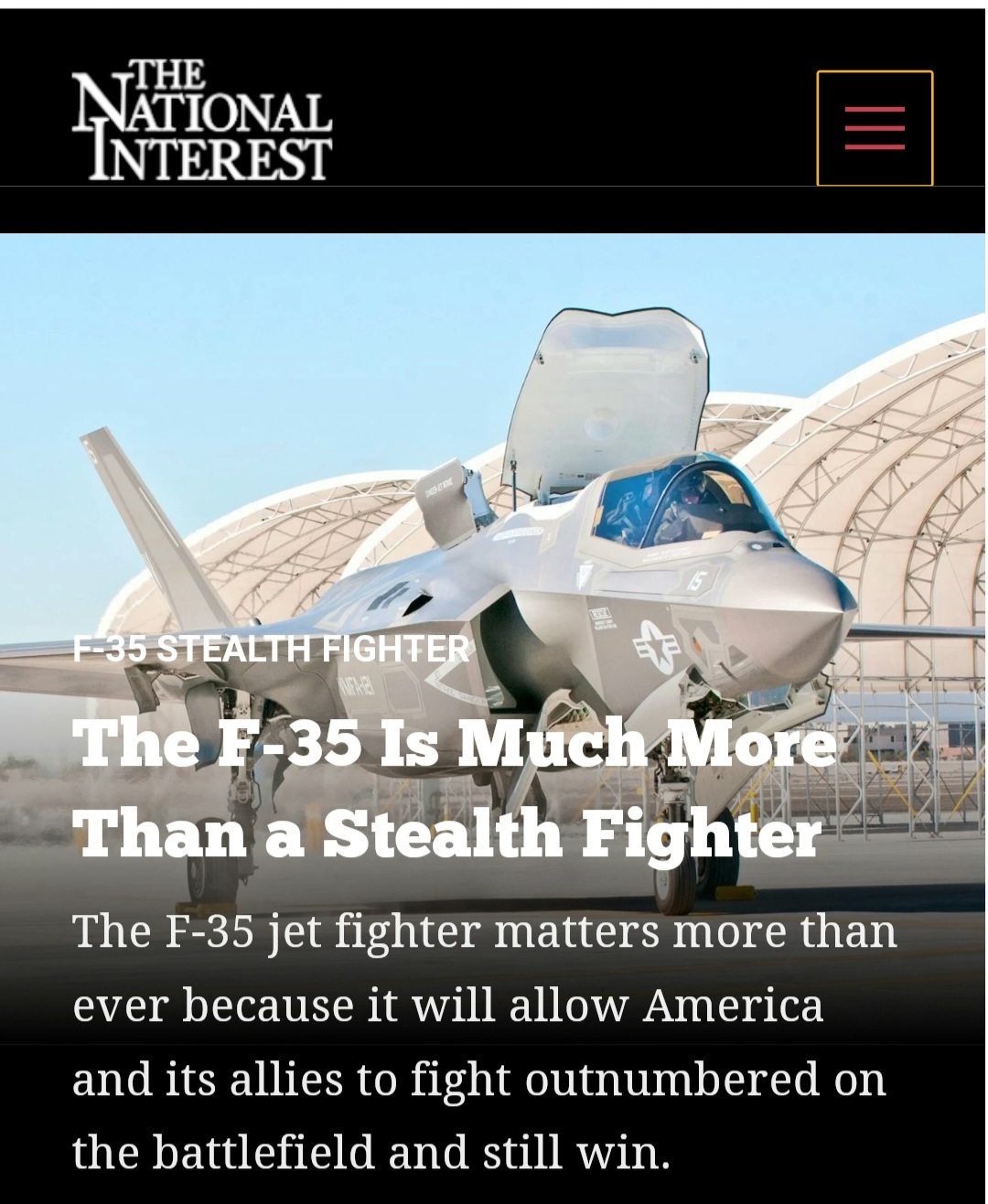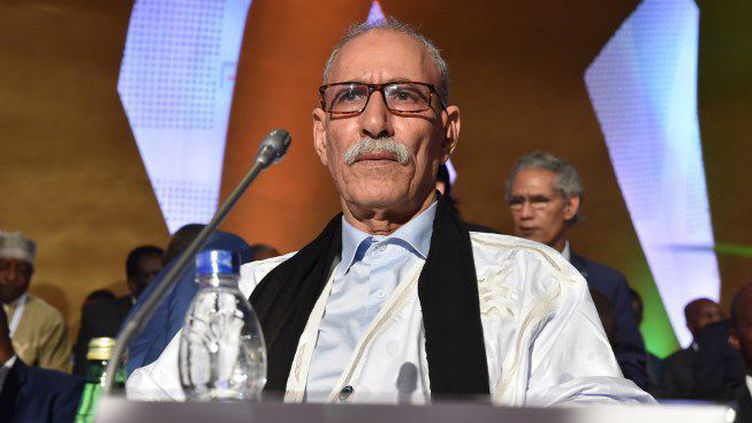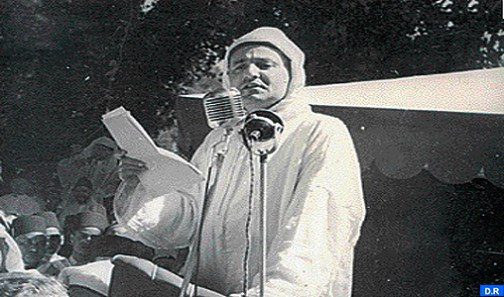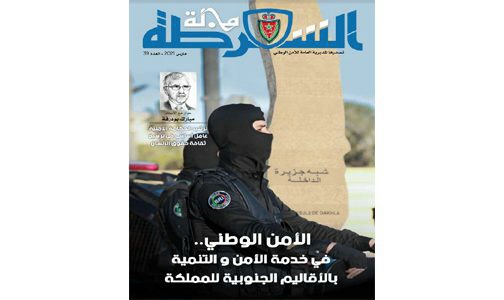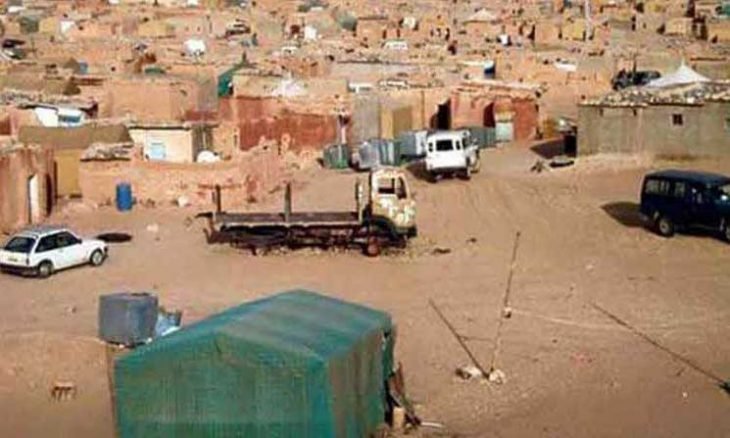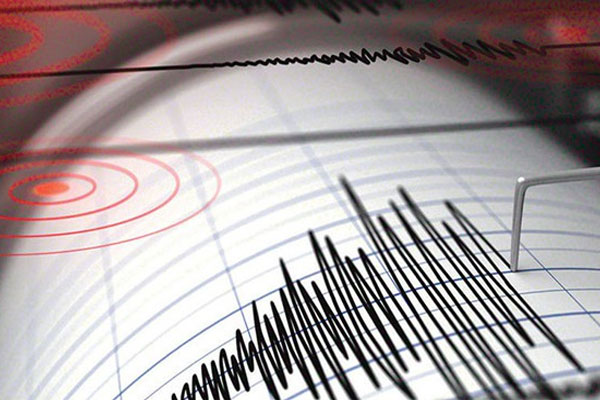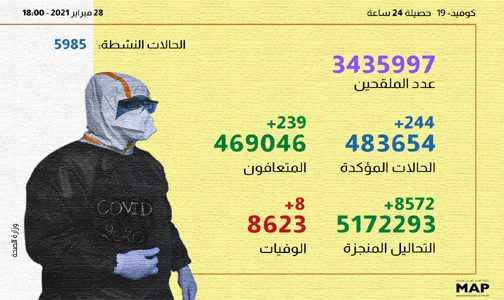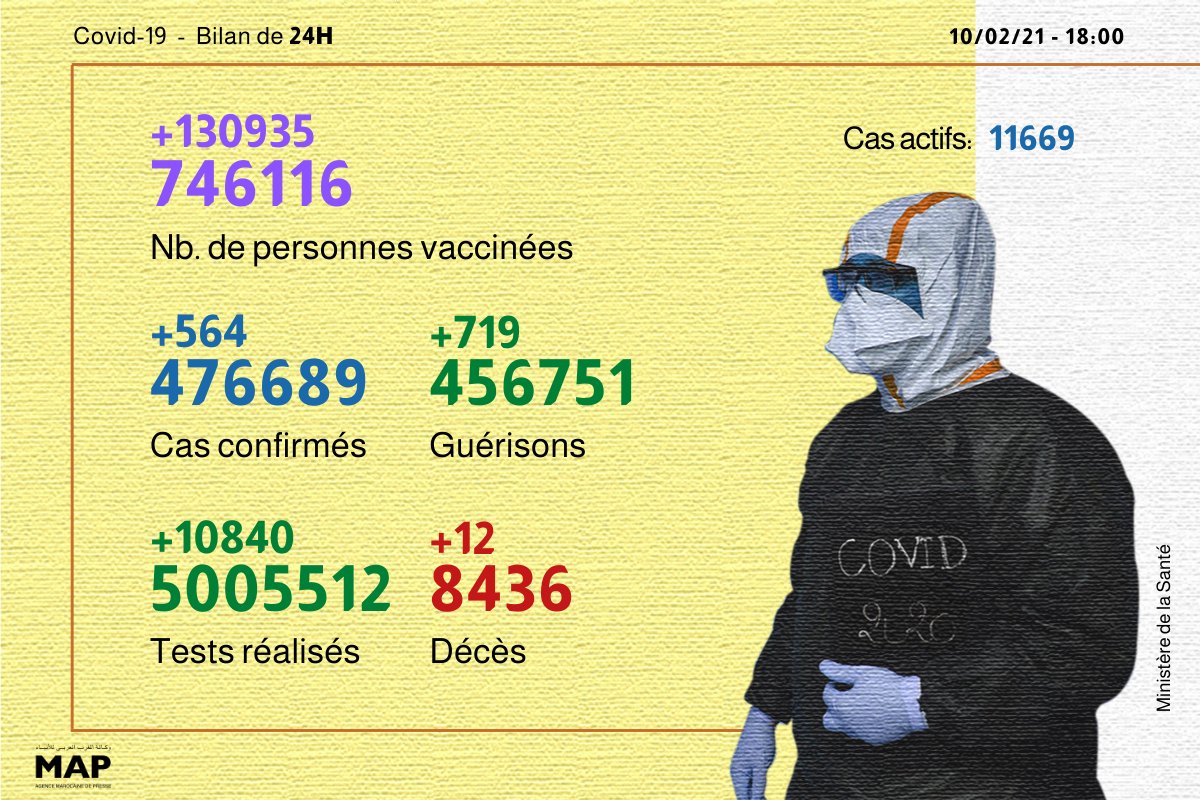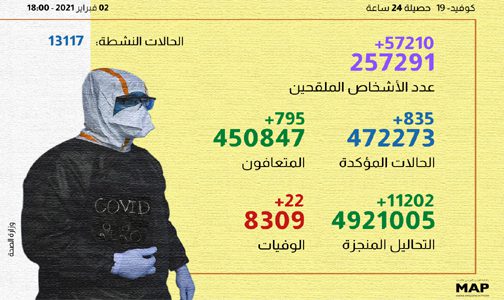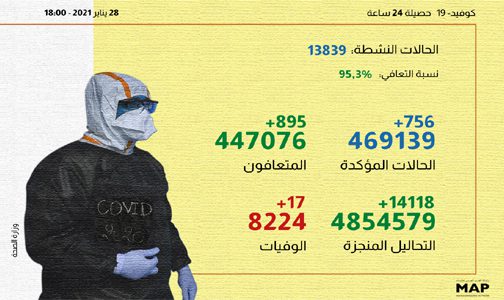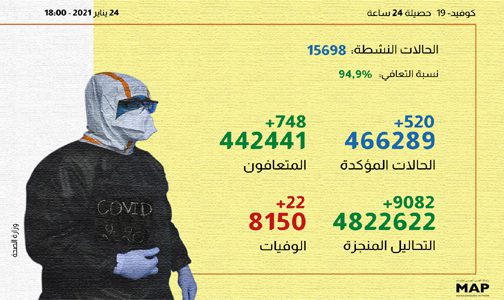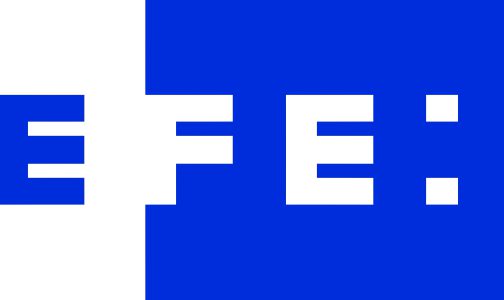بقلم: د.فؤاد بوعلي
احتفت حركة 20 فبراير يوم الأحد الماضي بذكراها الأولى. وهي مناسبة من المفروض على قراء الأحداث قبل صناعه قراءة واقع هذه الحركة ومسارها. ولا أحد في هذا الوطن يمكنه المزايدة على الدور التاريخي الذي قامت به وفعلها التغييري الذي يعيش المغرب بعض نسماته. حتى غدا قدرنا أن نتعلم من شبابنا وأن نردد مع قباني:”اضربوا..بكل قواكم .. واحزموا أمركم .. ولا تسألونا…نحن أهل الحساب..والجمع والطرح”. فقيمة الحركة، من بين قيم كثيرة، أنها غيرت الصورة النمطية التي تداولتها السلطة وحواريها حول الاستثناء المغربي ورفعت عاليا صوتها ضد الطغيان وحزب السلطة وهرم النخبة التي لم تعد تتقن سوى لك الكلام. ولمن شكك في الأمر فليسأل نفسه: هل مفاجئا أو صدفة تاريخية أن يعقد مؤتمر حزب السلطة ويتسيده أهم المطلوبين جماهيريا وشعبيا في الذكرى الأولى للحركة؟ وهل فعلا اقتنع السلطويون القدامى بضرورة الابتعاد عن إدارة الشأن العام بمنطق مخزني وترك الفرصة للشعب؟ لكن السؤال الأهم هو: هل استنفذت الحركة مبررات وجودها؟
في الذكرى السنوية للحركة قالت صحيفة “الواشنطن بوست” الأمريكية أن حركة 20 فبراير “ضلت طريقها” إلى الثورة، لتحقيق تغيير في المشهد السياسي للبلاد، موضحة أنه بعد مرور عام على انطلاق الحراك الشعبي في المغرب، فإن الحركة التي قادت الاحتجاجات في المغرب يبدو عليها الآن بعد عام من ولادتها أنها ضلت طريقها وإن كانت لا تزال تناضل من أجل الحصول على دور.
وعين المتابع لا يمكنها أن تخطئ الارتباكات المتعددة التي صاحبت تخليد الذكرى، بالرغم من مساحيق التجميل عند المنافحين عنها، ومحاولة العديد من الأصوات توجيه القافلة نحو رغباتها المكبوتة وغير المقبولة جماهيريا. فليس مفاجئا أن يظهر وسط الجموع صوت شاذ مثل أحمد الدغرني وحوارييه ليرفعوا لافتتهم ضد العروبة. وليس مفاجئا أن تبدو بعض الألوان الطائفية أو المذهبية أو الاثنية في مدن المغرب المختلفة مستغلة جو الحراك الشبابي. وليس مفاجئا أن تجد في خضم التظاهرة من لا يزال يعيش حلم ثورة الدم وتسليح الشعب. كما أنه ليس مفاجئا أن ينظر الناس إلى شباب حركة العشرين بنوع من اللامبالاة والاستغراب. والعلة في النشأة قبل البحث في المسار.
فمن المعروف أن حركة 20 فبراير قد حاولت استنساخ تجارب الربيع العربي المختلفة وثورات الساحات المتعددة من خلال أشكالها الاحتجاجية وتعبئتها الجماهيرية. لكن مسار الحركة يثبت عجزها منذ البداية عن استيعاب عمق هذه التجارب التي قادت التغيير من صلالة إلى تونس إلى القاهرة ودمشق والبقية تأتي. أي أنها لم تستطع فهم كنه نجاح شباب ساحات التحرير والصنوبر والتغيير في إحداث الثورة المطلوبة، وفشل الحركة بعد عام على انطلاقتها. ولذلك لن يفاجئك الضعف العددي الذي غدا ملمحا أساسيا للحركة وخرجاتها المختلفة. قد يلام في ذلك النظام السياسي بهالته الإعلامية وترسانته التدبيرية التي استطاعت احتواء جل التيارات السياسية والإيديولوجية. وقد يعلل الأمر بعدم قدرة المواطنين على مسايرة الحالة الشبابية المغربية وفورتها. وقد تتهم الأحزاب السياسية بترهلها التاريخي الذي جعلها خارج القدرة على الفعل والحركة. لكن الذي يلزم استيعابه أن أهم عوامل نجاح ثورات الربيع العربي أمور ثلاثة:
الفهم الدقيق لواقع التغيير وضرورته: فواقع مصر ليس واقع ليبيا وليس واقع تونس أو البحرين أو اليمن… والاستنساخ المطلق للتجارب يفضي إلى نهاية مأزومة. فصحيح أن الإحساس الجامع هو الذي حرك الشعوب العربية ووعاها بقدرتها على التغيير، لكن لكل واقع منطقه الخاص. فلو استعمل السلاح في الثورة المصرية لقضى عليها والعكس صحيح في التجربة الليبية.
رهانها على المشترك المجتمعي بدل التنابز الفئوي المفضي إلى الصراع الظرفي الطارئ. لذا اجتمع في الثورة المسيحي بالمسلم، والعلماني بالإسلامي، والفقير بالغني، والعربي بالأمازيغي…. فقدمت بذلك مفاهيم جديدة للوحدة والانتماء والوطن. حيث منحتنا ساحة التحرير بالقاهرة دليلا على الوحدة بين كل طوائف العروبة في مقاومة الجبروت. فأخذ الهلال بيد الصليب ليجلسه معه على عرش الانتصار، بالرغم من أنه لم يمض إلا وقت قصير على تفجير إرهابي تبينت خيوطه فيما بعد داخل دهاليز الأمن المركزي. وفي اليمن السعيد درس آخر حيث الوحدة بين الشمال والجنوب هيأت الظروف لثورة جامعة غابت فيها مصطلحات الانفصال والاستقلال. ولم يغير العنف المقحم على مسارها فكرتها السلمية والوحدوية.
تحديدها لسلم الأولويات في مسار التغيير حيث انصهرت الانتماءات السياسية والإيديولوجية لتفرز حراكا جماعيا يقدم إسقاط الآخر على الاختلاف مع المماثل مجتمعا وغاية. وبالرغم من أن قيادة الثورات كانت شبابية فإن وجود الأحزاب كان مدعما وحاميا وليس مسيطرا، مما مكن الشباب من الوصول إلى الهدف دون التيه في دروب الاختلافات الحزبية.
لكن مقاربة حركة 20 فبراير من خلال هذه الملامح يثبت العقم الذي غلفت به نفسها. فلا يتعلق العقم بالمطالب ولا بالظروف ولا حتى بمسار التغيير، لكن المقصود هنا هو تحريف مسار المطالبات. فلم نشهد على سبيل الاستدلال من يرفع الأعلام الفئوية أو الاثنية أو الحزبية في ثورات الربيع العربي المختلفة، بل ظل الهاجس الوحيد هو التغيير الذي وحد الجميع. لكن في المغرب سادت صورة أخرى. فبعد أن كان الجميع ملتفا حول أجندة المطالب التي يتغير سقفها حسب الانتماءات السياسية، شهدنا حديثا يحاول أن يغلف مطالب الشعب بخطاب قبلي فئوي وسيطرة لأعلام إثنية وتعدد إيديولوجي حضر بقوة في محاولة السيطرة على الحركة، وصراع سياسي لتوجيهها، وهو ما تم لتيار معين بعد انسحاب العدل والإحسان. كل هذا قزم عمق الحركة المجتمعي وجعلها فريقا من بين فرقاء بدل أن تكون محضنا لكل الفرقاء. فلكي تكون حركة لكل المغاربة وحركة تضمن لنفسها الوصول إلى التغيير ينبغي أن تجعل سقفها المشترك بين الجميع أو على الأقل الجزء الأكبر من أبناء هذا الوطن. فالمطلوب أن يجد كل مغربي نفسه في حركة ثائرة تستعيد زمن النضال والمقاومة وليس أن يجد نفسه غريبا عنها. لذا فالغربة التي أحس بها بعض نشطاء 20 فبراير وهم يخلدون ذكراهم الأولى وبتعبير أحدهم ينظر إليهم كأنهم من كوكب آخر، هو شعور متبادل وجدلي مع مواطنين تعبر الحركة عن بعضهم وتنكر جلهم. إن وهج الثورة المصرية، بالرغم من محاولة الاستيلاء والتحريف بعد النجاح، قد توفرت من إيمان شباب مصر بالوحدة أولا: بين كل الطوائف والتيارات والأديان، وسجلت لنفسها هدفا أوحد جندت له كل طاقاتها . فكان النجاح.
إن حاجة المغاربة إلى حركة 20 فبراير عظيمة وكبيرة. ومن اعتقد أنها قد استنفذت أغراضها بعد التعديل الدستوري والمسار الانتخابي فقد أخطأ الصواب. لأن التغيير لا يأتي دفعة واحدة. ورموز التسلط مازالت تجول مفتخرة بنصرها وتبرز قوتها في كل المنابر الإعلامية. والقانون مازال بعيدا عن التعبير الصادق عن حاجات المواطن…. لذا فالحاجة لشباب الحركة كبيرة، لكن لحركة جديدة تأخذ العبرة من ثورات الربيع العربي وتقدم نفسها محضنا لكل المغاربة.