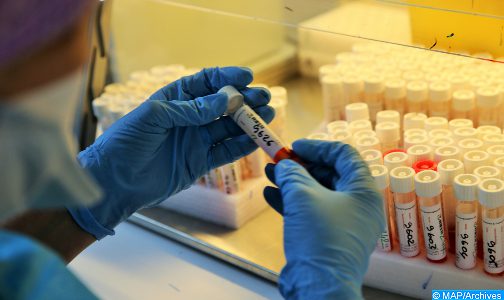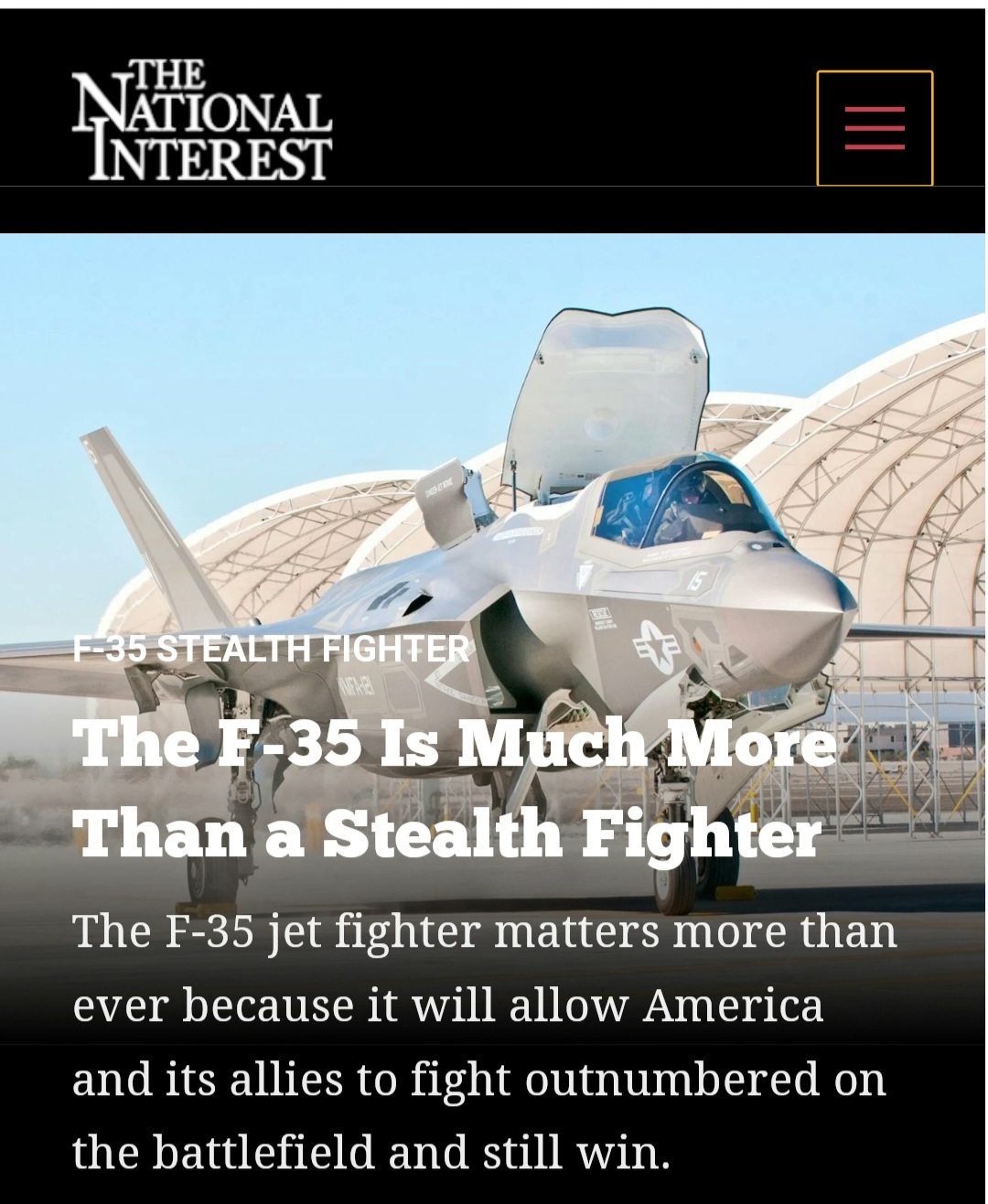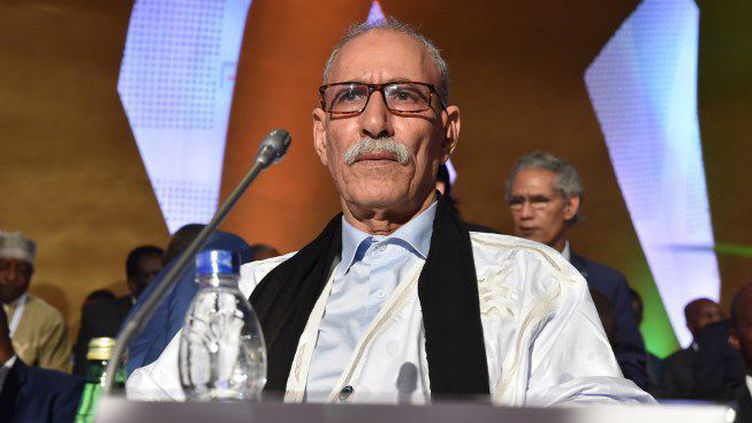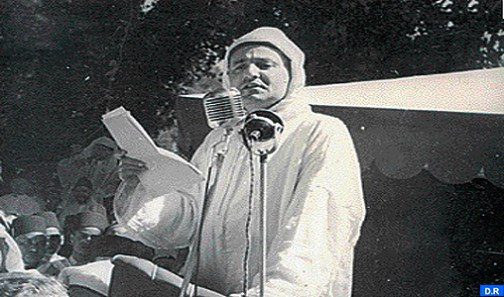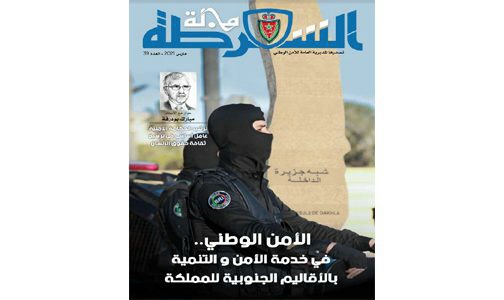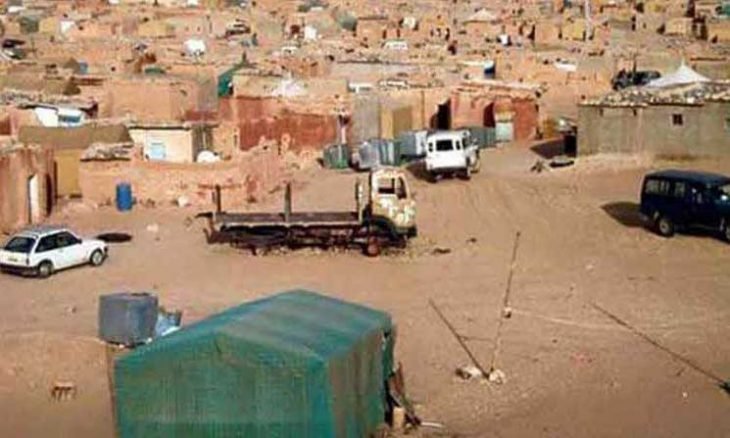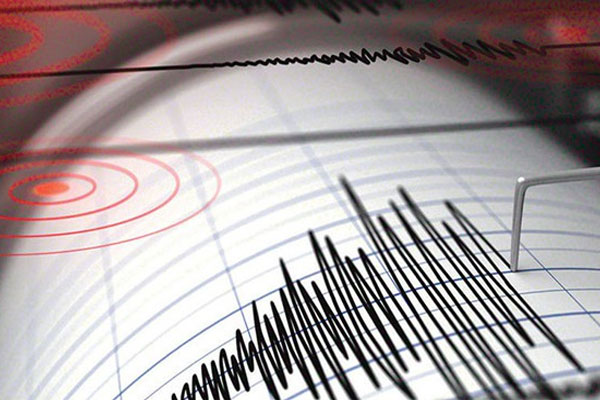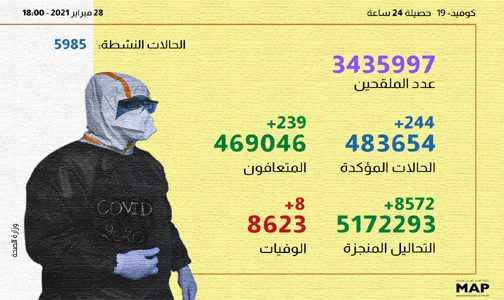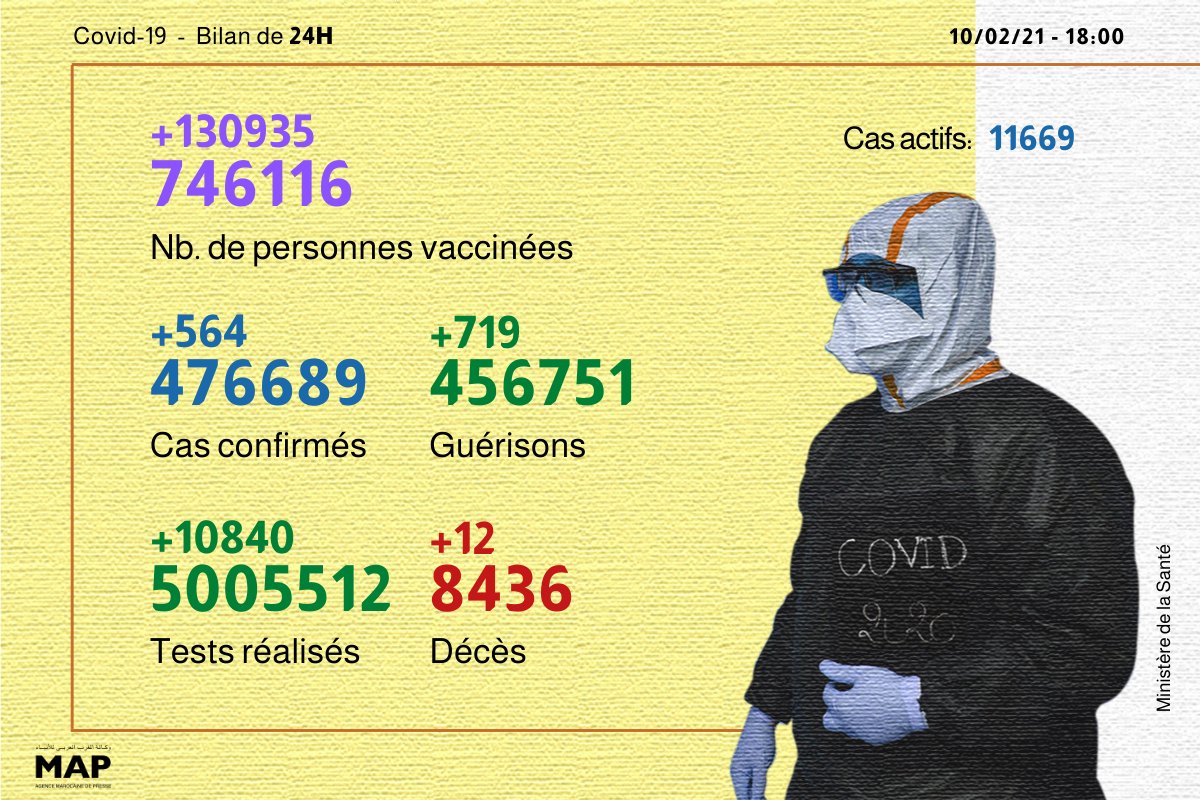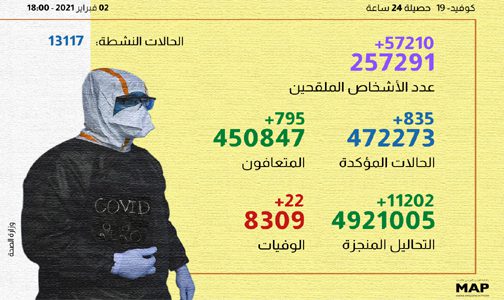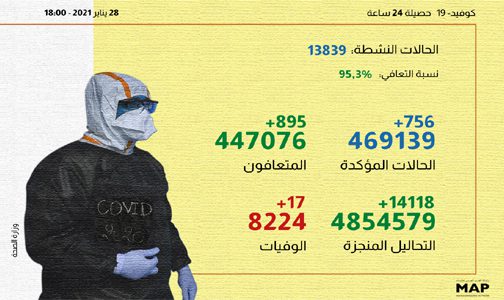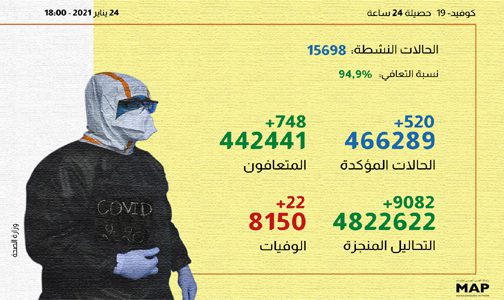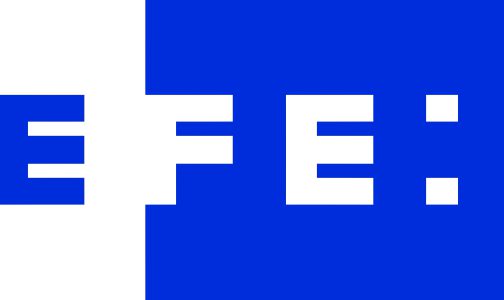بوريطة يستقبل وزير الشؤون الخارجية الغامبي حاملا رسالة خطية من رئيس جمهورية غامبيا إلى جلالة الملك
حين اقترحت الولاياتُ المتحدة، مؤخرا، توسيعَ نطاق تفويض بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية ليشمل مراقبة حقوق الإنسان، رفض المغرب الأمر ذلك، لأنه تقويضٌ لسيادته على الصحراء الغربية. فحقوق الإنسان تُصان بجهود مغربية، لا فرق أكان ذلك في العيون في الصحراء أو في مراكش ومكناس ونواحي البلاد الأخرى. تراجعت واشنطن، لكن المغرب لم يتراجع عن رفع لواء حقوق الإنسان، إلى درجة دعوة العالم إلى مدينة مراكش لمناقشة أمر ذلك على هذه الأرض، ضمن بيئة حقوقية مغربية هي الأولى في العالم العربي والسبّاقة في قيام منظومة في هذا المضمار.
في قلب مراكش انبسطت الأسبوع الماضي قرية عالمية استضافت أحياؤها الملتقى الدولي الثاني لحقوق الإنسان. التقى الجمع في المرة الأولى في البرازيل في أوائل العام الماضي، أراد المغرب استضافة المنتدى الثاني هذا العام فكان له ما أراد (كان مقرراً أن تستضيفه الأرجنتين). فللمغرب باعٌ في مجالات الدفاع عن حقوق الإنسان، سواء من خلال المجتمع المدني ومنظماته، أو من خلال الأداء الرسمي والحكومي.
كان لا بد لذلك الجهد المميّز في مجال حقوق الإنسان في المغرب أن يطل على العالم من قلب مراكش. تصالح المغرب مع نفسه منذ تقلّد الملك محمد السادس عرش البلاد. كان بإمكان الملك الشاب أن يرث الحكم ويكمل مسيرة من سلف، لكنه قرر العودة إلى تلك المسيرة، ليفتح كافة الملفات، ويحقق في كل الانتهاكات ضمن “هيئة الإنصاف والمصالحة “التي أنيطت بها تلك المهمة، مؤسسا بذلك منظومة سلوك تنسحب على كافة القطاعات المعنيّة بحقوق الإنسان.
أملَ المنظمون أن يصل عدد المشاركين إلى خمسة آلاف شخص، فجاءهم أكثر من 8 آلاف “يحجّون”، إلى مراكش في أكبر مظاهرة كونية للدفاع عن حقوق الإنسان. في المشهد ما يعكسُ هماً مشتركاً ما بين القارات والأجناس والثقافات. وفي المشهد يختلطُ الجنوب بالشمال، وتتقاطع الدول الغنية والنامية والفقيرة. في المشهد عودةٌ عجيبة إلى أصل الحضارة وأساس وجودها: الإنسان.
يُصدَمُ المراقب كم أن مسألة حقوق الإنسان عاجلةٌ طارئةٌ ملحّةٌ في زمن العولمة والتقدم التكنولوجي، وكم هي مقلقةٌ في زمن رواج الديمقراطية والتبشير بالحريات كقاعدة عيش في العالم أجمع. في النقاشات التي اشتعلت داخل خيام المنتدى مرايا لتخلّف ما زال سائدا في تعامل البشر مع البشر، في تعاطي السلطة مع المواطن، في مقاربة الذكر للأنثى، وفي سلوك المجتمعات مع أطفالها. وإذا ما ولى زمن الاستعباد والرقيق بمعناه المباشر الفجّ، فإن تلك السيرة تستوطن زمننا بخبث ودهاء وفق أشكال وأساليب متخفية أحياناً، وعلنية أحياناً أخرى.
في الجدل حول أمر الإنسان وحقوقه، أفرجت مراكش عن ديناميات المشكلة، عن مواطن العلّة، عن تعطل علاجها. في السياسة ما يكشف ظلماً وتعذيباً وتسلطاً واستبدادا. وفي الثقافة ما يبررُ خللا في التعاملات المجتمعية الداخلية. وفي الاقتصاد ما يفسّر بطالة وعمالة أطفال ورواج ظواهر الاستغلال. وفي الذكورية ما يسلّط المجهر على اختلال لئيم في مساواة الرجل بالمرأة من شمال شمال الأرض إلى جنوب جنوبها، وما يكررُ النقاش حول الاستغلال الجنسي الخبيث الذي ما زال يطال المرأة والطفل في القرن الواحد والعشرين.
وفيما دارت ورشُ منتدى مراكش حول ما يمكن وصفه بالانتهاكات الكلاسيكية التي لا تنتهي منذ بدء الكون، فإن حال حقوق الإنسان عند العرب تدخل في أطوار ذاتية، تتجاوز كلاسيكيتها العالمية الرتيبة. فتناول ذلك الشأن لطالما كان بعيداً عن أجندة الحاكم منذ زوال الاستعمار والدخول في حقبة الاستقلال، ولطالما اعتبرت الأدبيات الأيديولوجية الحاكمة أن إثارة المسألة هي رجس من عمل الخارج، ومؤامرة دولية ضد منجزات الدولة الوطنية المتحررة من سطوة القوى الكبرى.
في ظل الأنظمة الجمهورية تحوّل الإنسان إلى تفصيل تافه داخل مفهوم “الجماهير” التي ادعت تلك الأنظمة الدفاع عنها. تحوّل الإنسان إلى وقود وطاقة لرفد الأنظمة الثورية، كما أضحى أضحية شرعية يُستهان بمصيره في سبيلها. راج شعار “لا صوت يعلو فوق صوت المعركة”. لم تكن المعركة، بالضرورة، حرباً ضد عدو، بقدر ما اعتبرت نزالا مستمراً ضد خصوم النظام ومنتقديه.
وفق ذلك الشعار “المقدس” استباحت السلطة حقوق الفرد في أن يكون حراً تبيح حريته الشرائع والأديان التي ادعت الأنظمة أنها تستلهم الشرعية منها.
وإذا ما كانت الأنظمة غير الجمهورية عند العرب تستمدُ شرعيتها من استمرار تاريخي بعيد، فإن ثقافة الحكم ومفهوم استقراره استندت أيضاً على استبداد، وتعاملت مع الإنسان بصفته من رعايا العرش، وعبر تلك الصفة لا ينعم إلا بالحقوق التي أرادها صاحب ذلك العرش. في ذلك تفسير لظواهر تخلّف في الأداء الحقوقي، على ما تفرج التقارير وتكشفُ التحقيقات، ليس فقط في علاقة المواطن بالحكم، بل في العلاقات المجتمعية الداخلية بين رجل وامرأة وطفل. وفي هذا، سجل المغرب في ظل محمد السادس، قطيعة نهائية مع نهج وسلوك سابقين.
وإذا ما جاء “ربيع” العرب مبشّراً بانبلاج فجر الإنسان وحقوقه، أتت الرياح بما لم تشته سفن الزاحفين في الشوارع. فلا قطع الرؤوس ولا اغتصاب النساء ولا انتشار التعذيب ولا ارتكاب المجازر يشي باحتمالات أن يطل عهد قريب لحقوق الإنسان في ربوعنا. يكشف هذا “الربيع” عن علّة بنيوية في تركيبة مجتمعاتنا تفرز علل الاستبداد والتفرد واللجوء إلى العنف سواء كانت السلطة في يد هذا، أو استولى عليها ذاك. ويكشفُ هذا “الربيع” في تهافت الإسلام السياسي على السلطة إشكالية تحكّم الدين، أو من يدعون التكلم باسمه، بيوميات الفرد وإيقاعات تطوره. يكشفُ “الربيع” استعصاءً إشكالياً لمقاربة ما من شأنه تخليص الإنسان العربي من حمولات ثقافية على طريق تحرير الإنسان وصون حقوقه.
يدلي المغرب بدلوه في الجدل الكوني الراهن حول حقوق الإنسان. تستطيع الرباط، كحكم وسلطة، أن تفتخر في سجل متطوّر في هذا المضمار. ويستطيع المغرب، شعبا وتيارات وأحزاب وجمعيات، أن يفتخر بإنجازاته في هذا الميدان. أنشأ المغرب المجلس الوطني لحقوق الإنسان عام 2011 (حل محل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان)، وهو مؤسسة جماعية، مستقلة تم إنشاؤها من أجل التعاطي مع شتى الإشكاليات المتعلقة بالدفاع وحماية حقوق الإنسان والحريات، ومن أجل الامتثال الصارم للمرجعية الحقوقية بصيغتها الكونية.
يذهبُ العاهل المغربي الملك محمد السادس في رسالته للمنتدى مباشرة ودون مواربة: “كونية حقوق الإنسان لا تعني أبدا التعبير عن فكر أو نمط وحيد، بل يجب أن تشكّل في جوهرها، نتاجا لدينامية انخراط تدريجي (…) تجد فيه التقاليد الوطنية والثقافية مكانها الطبيعي، حول قاعدة قيم غير قابلة للتقييد، دون تعارض أو تناقض معها”.
شراكتنا كاملة في هذا العالم. هكذا يصيغ ملك المغرب رسالته، وبناء على ذلك نذهب معاً للإجابة على إشكالات الراهن: “رفض الآخر والتعصب، بسبب مبررات عرقية، أو قراءة منحرفة لنبل رسالات الأديان، إلى انتهاكات صارخة للحقوق الأساسية، بما فيها أقدس هذه الحقوق، ألا وهو الحق في الحياة”.
يطل محمد السادس من مراكش من منبر كوني ليعيد تصويب البوصلة نحو المغرب. يمعن في التقدم نحو “مسألتي المساواة والمناصفة، المدرجتين في دستور المملكة، باعتبارهما أهدافا ذات طبيعة دستورية”. يفتخرُ الملك المغربي بما حققته بلاده “بعد خمس عشرة سنة من الجهود المشتركة، بحصيلة مشرفة من الإنجازات، تشمل ميادين حيوية، من قبيل العدالة الانتقالية، وحقوق المرأة، والتنمية البشرية، ورد الاعتبار للثقافة الأمازيغية كمكون أساسي للهوية المغربية، وتوطيد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتدبير الحقل الديني، على أساس المبادئ والتعاليم والمقاصد السمحة للإسلام”.
هي ورشة كبرى طموحة خاطر بها المغرب وما فتئ عاهل البلاد يتابع سيرها وصيرورتها، يرد بذلك على المشككين والمترددين في الإيمان بنهائية الرقي بحقوق الإنسان باتجاه أعلى القمم المتاحة.
أمام ميدان المؤتمر، وعلى مدى الأيام الأربعة التي انعقد خلالها، لم تتوقف مظاهرات واعتصامات مطلبية لقطاعات مغربية. أسأل واحداً من كبار المسؤولين في المجلس الوطني للحقوق الإنسان في المغرب، أين أنتم من هذه الحكاية؟ يبادرني بلغة الأرقام: عام 2011 بلغ عدد المظاهرات في المغرب 22 ألف مظاهرة، وتناقص هذا العدد كل عام، وهو يبلغ حتى هذه الأيام من العالم الحالي 16 ألفاً. وماذا يعني ذلك؟ يجيبني أن الناس كانت تخرجُ في المظاهرات بصفتها سلوكاً استثنائياً، فأشبعوا هذا الحرمان حتى التخمة، وبات الأمر اعتيادياً في المشهد الاجتماعي والأمني والسياسي.
لم يعد التظاهر في المغرب يعكس أزمة نظام، بل بات دليلا على توازن واتساق مع ما هو حاصل ومعمول به في العالم. هكذا أدرك الحقوقيون الأجانب القادمون من شتى أنحاء الأرض المراتب المتقدمة التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان، فكان صراخهم عاليا يصدر واثقا منطلقا من أرض مراكش الصلبة حيث الإنسان ما زال أصل الحضارة.
صحافي وكاتب سياسي لبناني