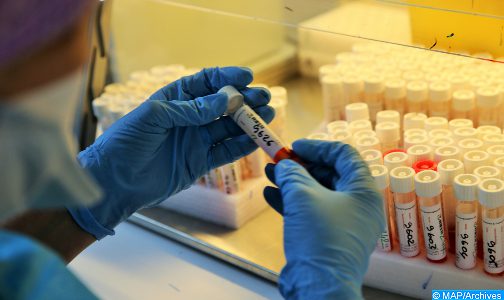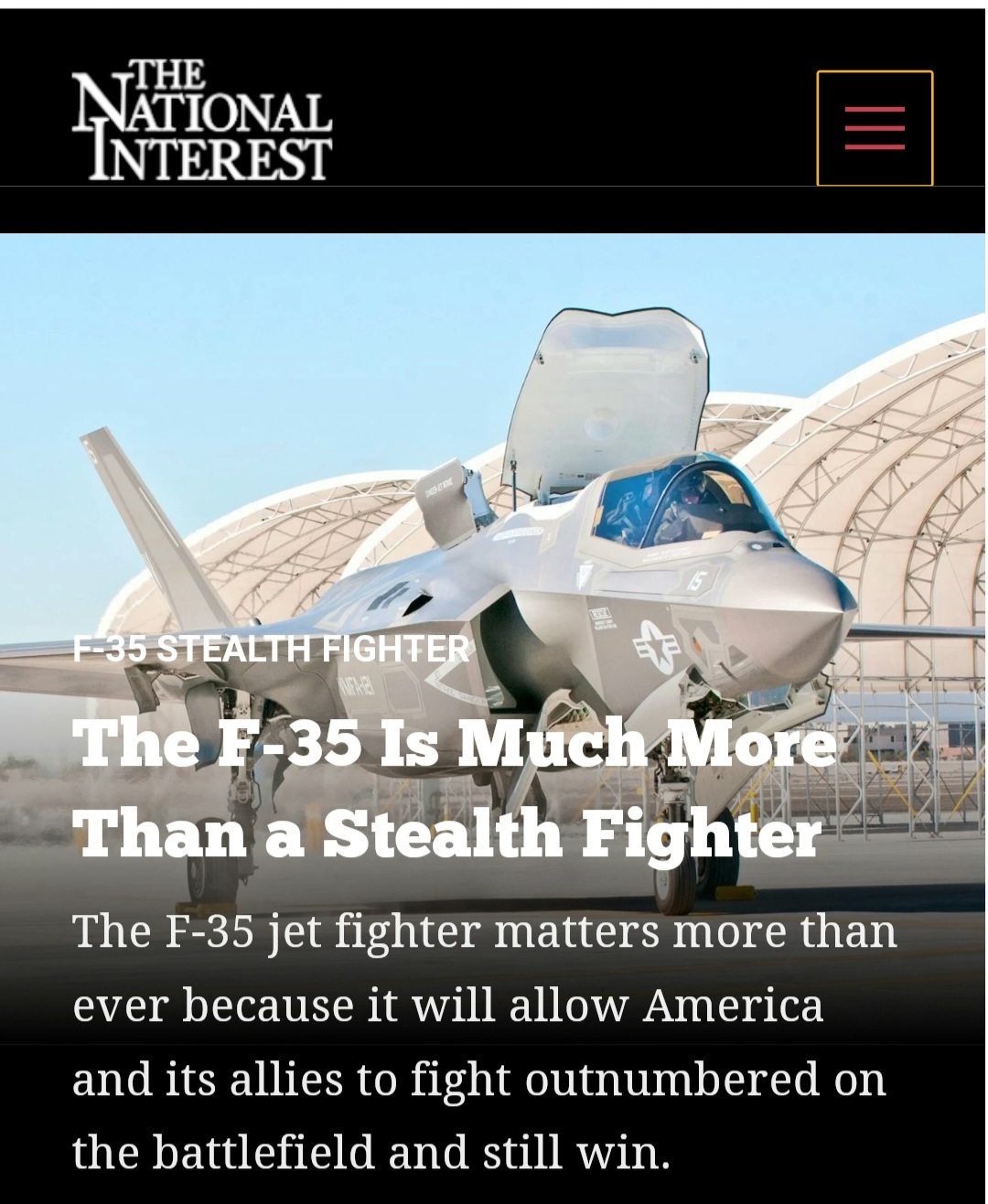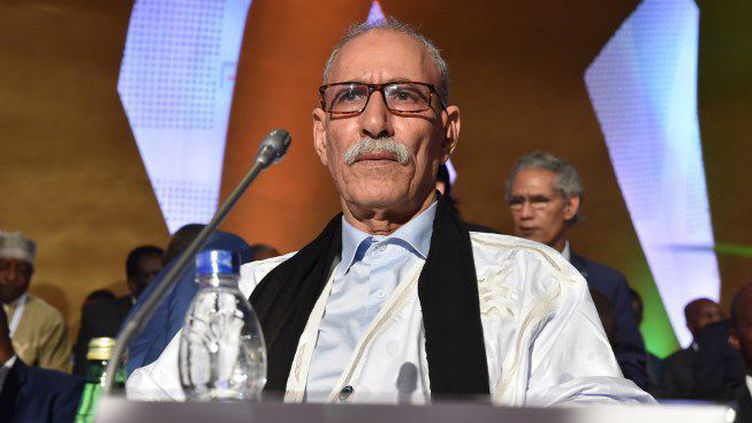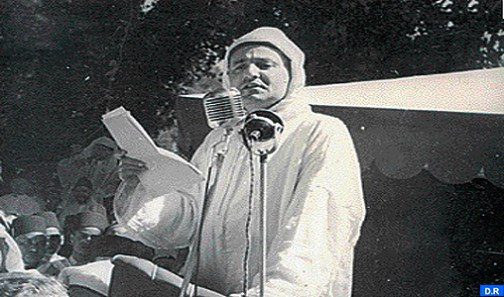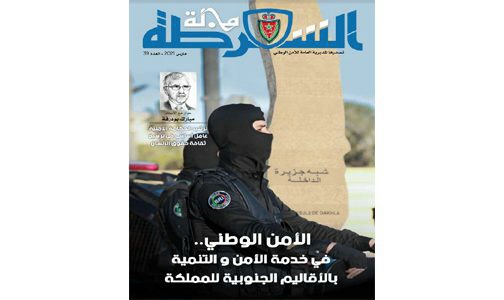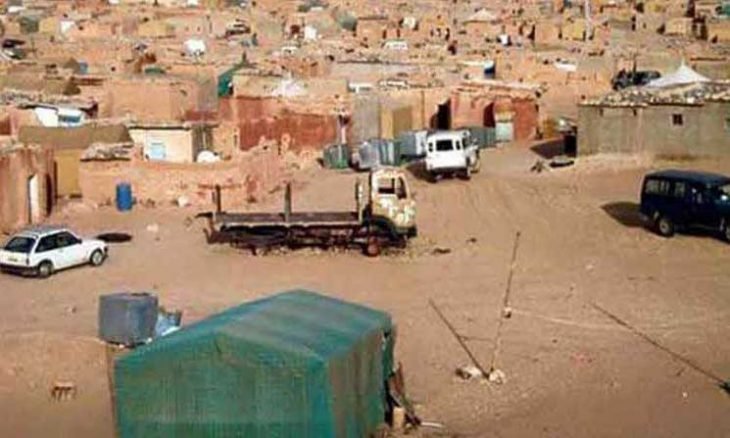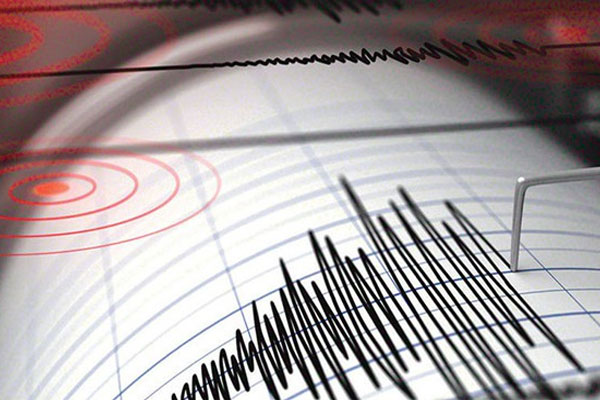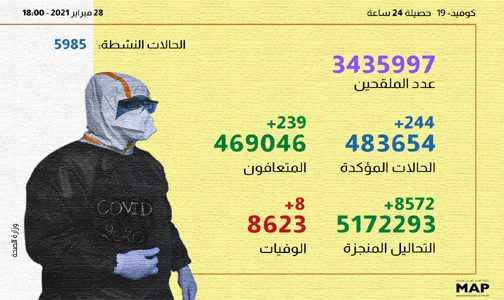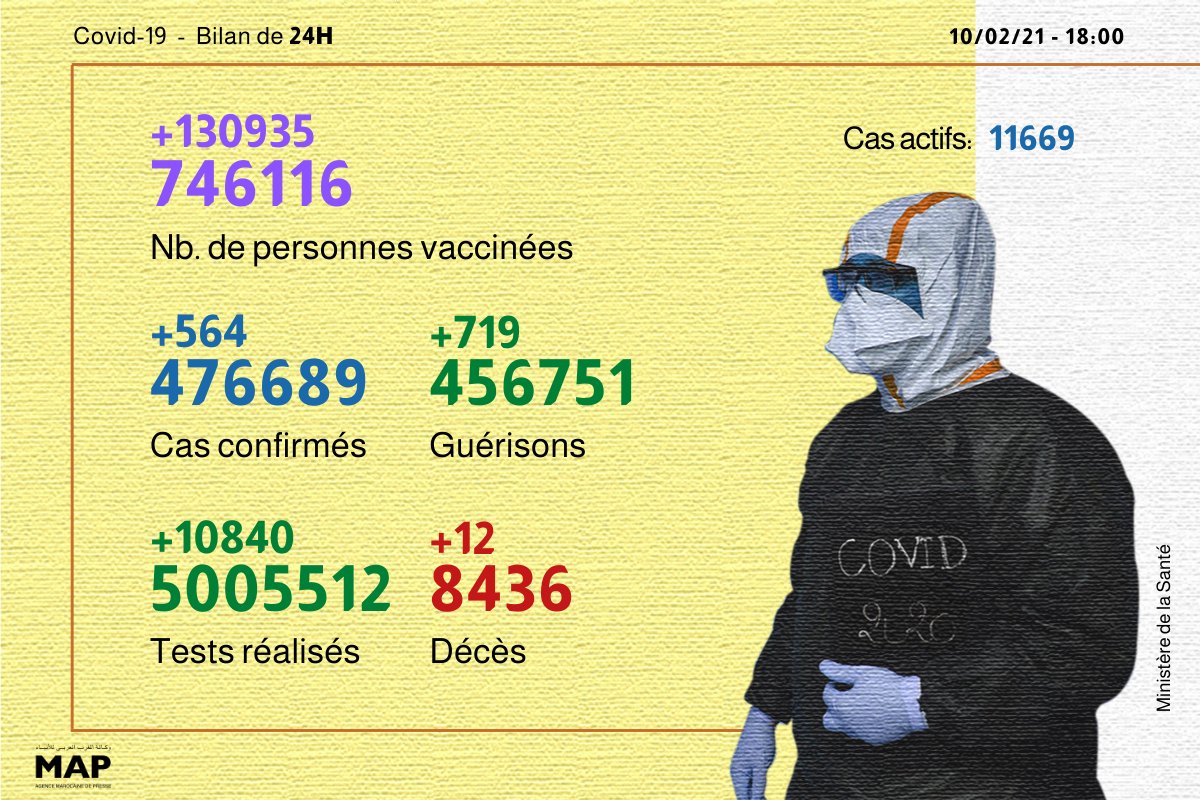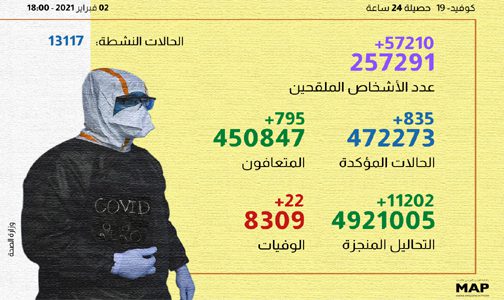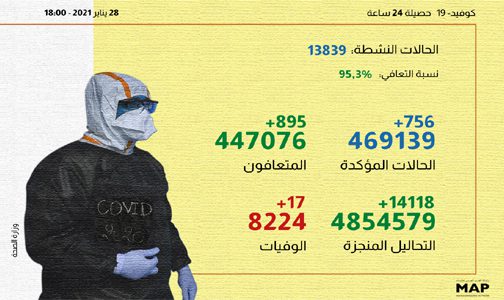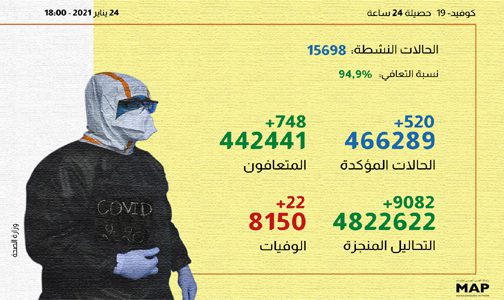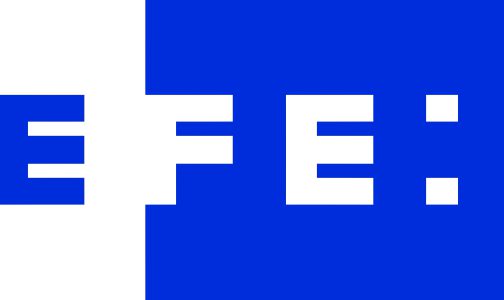بلاغ: فتح تحقيق تقني إثر حادث تعرضت له طائرة تابعة لشركة ‘إير أوسيان’ بفاس

تسلم يوم 4 يناير 2010 النقيب الأستاذ محمد الناصري مقاليد وزارة العدل، ويوم 4 يناير 2012، أي سنتين بعد ذلك بالتمام والكمال تمت مراسيم تسليم السلط بين الوزير المنتهية مهمته والوزير الجديد مصطفى الرميد.
وأتذكر بأنني، مباشرة بعد تعيين النقيب الأستاذ محمد الناصري، كتبت ورقة نُشِرَتْ على صفحات يومية “الصباح” أبرزت فيها خصال الرجل الذي عرفته كنقيب وَمُعَلِّمْ تتلمذت على يديه أجيال من المحامين بهيئة الدار البيضاء.
وتشاء الأقدار أن يخلفه على رأس وزارة العدل محام من نفس الهيئة، تجمعني به روابط قوية من الصداقة والزمالة، وأدين له، هو الآخر، بكل ما فتحه من آفاق في مساري التشريعي، رغم ما ترتب عن ذلك من متاعب ومشاق هو أعلم بها من غيره.
إن ما أكنه لمصطفى الرميد من صداقة وتقدير لا يؤهلني لتقديم الرجل بما يلزم من تجرد، إلا أنني سأحاول قدر الإمكان أن أبرز بعض جوانب هذه الشخصية المتميزة، لعلني أساهم في التعريف بها بشكل يخرج بالقارئ عن الأنماط والكليشيات المتداولة.
وأثير انتباه القارئ الكريم من الآن أنني لن أعتمد أية منهجية في هذا المسعى، بل سأترك لقلمي الحرية المطلقة للتعبير بكل عفوية، عسى أن أتجاوز بتلقائية العرض ما أعترف به من عجز على التجرد.
إن ما يميز مصطفى الرميد، إلى جانب سمو أخلاقه وتهذيبه، هو الكرم بمفهومه الشامل، فكلما دخلت بيته إلا ووجدته مملوءا بأصناف من الضيوف من أصدقاء وهم عديدون ومحامون، وسياسيون، يتجاذبون أطراف الحديث حول موائد مثقلة بكل ما يلد ويطيب، ودليلي على كرم الشخص أنه يفوقني في الوزن رغم أنني أفوقه في القامة.
ومصطفى الرميد ليس كريما بالمفهوم التقليدي فقط، بل إنه كريم حتى بدرايته وخبرته، ولما وُضِعْتُ أمام مسؤولية الإشراف على عمل الفريق البرلماني الذي أنتمي إليه داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، في وقت جد مبكر من تجربتي البرلمانية الأولى، كان رئيس الفريق، مصطفى الرميد، لا يبخل علي بنصائحه وخبرته. لقد كنا نعمل معا على صياغة المداخلات والتعديلات في ظروف وأماكن شتى، إما بمنزل أحدنا، حيث كانت له حصة الأسد في هذا الجانب، أو مكتبه للمحاماة، أو حتى على متن القطار في طريقنا إلى الرباط.
وكرم مصطفى الرميد لا يوازيه إلا ذكاؤه، إذ للرجل قدرة خارقة للعادة على استيعاب الأشياء، والوصول إلى المقصود بدون عناء، حتى أن أعصابه كانت في غالب الأحيان تتوتر، لأن من طبيعتي أن لا أستعيب الأمور بالسرعة التي حباه الله بها، فكنت دائما أجند كل ما لذي من ملكات وقدرة على التركيز لتقليص مسافة الفهم والاستيعاب بيني وبينه، إلا أنني غالبا ما كنت أفشل في مسعاي هذا.
إلى جانب ذلك يمتاز الرجل بالتواضع التام، بل إن شخصيته تطبعها البساطة في كل ما تحمل هذه الكلمة من نبل، مع استثناء ملحوظ لَمَّا يَفْتَخِرُ بانتمائه الدكالي في إحدى الجلسات المرحة التي يجتمع فيها بأصدقائه.
ولعل خصال الرجل السياسي والمسؤول الحزبي معروفة أكثر عند العموم، إلا أن بعض الجوانب منها تتطلب التدقيق والتوضيح.
فالرجل معروف بحزمه وشعوره بالمسؤولية، ويفسر البعض ذلك بأنه متشدد ومنفعل.
نعم، إن مصطفى الرميد متشدد لأنه يحب العمل المتقون، وهو شديد الانفعال كلما رأى أن الأمور لا تسير في الاتجاه الصحيح، فهو لا يرتاح له بال إلا إذا اطمئن على جودة العمل ومستوى إتقانه، أما الرداءة فإنها تلهب مشاعره وتؤجج انفعاله.
فيما عدا ذلك يبقى مصطفى الرميد رجل مرح، خفيف الدم، عذب المعاشرة، فقد حصل يوما أن جلس إلى جانبي في إحدى الصفوف المتأخرة بقاعة الجلسات العلنية بمجلس النواب، فتحلقت حولنا مجموعة من المصورين أمطرونا بومضات آلاتهم، ولما انتهوا من أخذ صورهم التفت إلي مصطفى الرميد وقلت له: إسمع: كلما كانت لك رغبة في أن تجلب المصورين إليك ما عليك إلا أن تجلس بجانبي ) أنا الذي لا أثير انتباه المصورين لا داخل قبة البرلمان ولا خارجها ( !
وفي مناسبة أخرى كنت أنا ومجموعة من الإخوة في الحزب في ضيافة مصطفى الرميد في يوم من أيام رمضان المنصرم، وكنت جالسا في حديقة منزله تحت شجرة تين، ربما استلهمت من صاحب الدار كل كرمه، وبادرتني بقطرات من فاكهتها المتفتحة حَوَّلَتْ قميصي – الكندورة – إلى لوحة تشكليلية من نوع خاص، فألح مصطفى الرميد على أن أرتدي قميصه الشخصي للرجوع إلى بيتي.
ولما التقيته بعد أسبوع من هذا الحادث قلت له مازحا بأنني قضيت الليلة في الإفتاء على غير عادتي في السياسة وشعابها، ولم أفهم أن سِرَّ هذه النباهة المفاجئة يكمن في القميص الذي ناولني إياه، إلا بعد أن شكرني الأشخاص الذين استفتوني، بعبارة “شكرا السي مصطفى”.
هذا هو مصطفى الرميد كما أعرفه، جدي ومرح في آن واحد، والذي أتمنى له كل النجاح في المهمة الصعبة التي تنتظره على رأس وزارة العدل والحريات.
أكورا بريس: عن موقع “العدالة والتنمية”